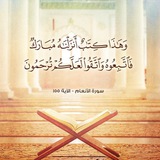اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ
أعمال القلوب
#ورد التفسير الموضوعي
#أعمال القلوب
من أعمال القلوب التي ورد ذكرها في سورة الحجر:
1️⃣ النهي عن الحزن على الكافرين:
في قوله تعالى:
{لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ *وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} (88)
📚أي: وَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا؛ فإنهم لا خير فيهم يرجى، ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض.
وَقِيلَ: لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَارُوا إِلَى الْعَذَابِ فَهُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ.
وفيه نَهْيٌ لَهُ عَنِ الِالتِفاتِ إلَيْهِمْ، وأنْ يَحْصُلَ لَهم في قَلْبِهِ قَدْرٌ ووَزْنٌ.
(الرازي والقرطبي والسعدي)
📕{ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾
"كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا؛ فَيُخَلِّصُوا أنْفُسَهم مِنَ النّارِ؛ ويَقْوى بِهِمْ جانِبُ الإسْلامِ." (البقاعي)
-
📔"والنَّهْيُ عَنِ الحُزْنِ شامِلٌ لِكُلِّ حالٍ مِن أحْوالِهِمْ مِن شَأْنِها أنْ تُحْزِنَ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - وتُؤْسِفُهُ، فَمِن ذَلِكَ:
▪︎ كُفْرُهم كَما قالَ تَعالى ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذا الحَدِيثِ أسَفًا﴾ [الكهف: ٦]،
▪︎ ومِنهُ حُلُولُ العَذابِ بِهِمْ مِثْلُ ما حَلَّ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَإنَّهم سادَةُ أهْلِ مَكَّةَ، فَلَعَلَّ الرَّسُولَ ﷺ أنْ يَتَحَسَّرَ عَلى إصْرارِهِمْ حَتّى حَلَّ بِهِمْ ما حَلَّ مِنَ العَذابِ.
فَفي هَذا النَّهْيِ كِنايَةٌ عَنْ قِلَّةِ الِاكْتِراثِ بِهِمْ، وعَنْ تَوَعُّدِهِمْ بِأنْ سَيَحِلُّ بِهِمْ ما يُثِيرُ الحُزْنَ لَهم" (التحرير والتنوير)
📗"الصَّحِيحُ في مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: أنَّ اللَّهَ نَهى نَبِيَّهُ ﷺ عَنِ الحُزْنِ عَلى الكُفّارِ إذا امْتَنَعُوا مِن قَبُولِ الإسْلامِ. ويَدُلُّ لِذَلِكَ كَثْرَةُ وُرُودِ هَذا المَعْنى في القُرْآنِ العَظِيمِ.
• كَقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تَكُ في ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]،
• وقَوْلِهِ: ﴿فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ﴾ [فاطر: ٨]،
• وقَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ألّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾،
• وقَوْلِهِ: ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذا الحَدِيثِ أسَفًا﴾ [الكهف: ٦]،
• وقَوْلِهِ: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنهم ما أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيانًا وكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلى القَوْمِ الكافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٨]،
إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.
والمَعْنى: قَدْ بَلَّغْتَ ولَسْتَ مَسْئُولًا عَنْ شَقاوَتِهِمْ إذا امْتَنَعُوا مِنَ الإيمانِ، فَإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ وعَلَيْنا الحِسابُ، فَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إذا كانُوا أشْقِياءَ." (الشنقيطي)
2️⃣اليقين
في قَوْلُهُ تعالى:
﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾
📔"قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سَالِمٌ: (الْمَوْت)
وَسَالِمٌ هَذَا هُوَ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَغَيْرُهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾
[الْمُدَّثِّرِ: ٤٣-٤٧]
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْيَقِينَ الْمَوْتُ حَدِيثُ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ.
وفيه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ -وَقَدْ مَاتَ -قُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله أكرمه؟ " فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ؟ فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ"
(البخاري)
وَيُسْتَدَلُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ -عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب".
#أعمال القلوب
من أعمال القلوب التي ورد ذكرها في سورة الحجر:
1️⃣ النهي عن الحزن على الكافرين:
في قوله تعالى:
{لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ *وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} (88)
📚أي: وَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا؛ فإنهم لا خير فيهم يرجى، ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض.
وَقِيلَ: لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَارُوا إِلَى الْعَذَابِ فَهُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ.
وفيه نَهْيٌ لَهُ عَنِ الِالتِفاتِ إلَيْهِمْ، وأنْ يَحْصُلَ لَهم في قَلْبِهِ قَدْرٌ ووَزْنٌ.
(الرازي والقرطبي والسعدي)
📕{ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾
"كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا؛ فَيُخَلِّصُوا أنْفُسَهم مِنَ النّارِ؛ ويَقْوى بِهِمْ جانِبُ الإسْلامِ." (البقاعي)
-
📔"والنَّهْيُ عَنِ الحُزْنِ شامِلٌ لِكُلِّ حالٍ مِن أحْوالِهِمْ مِن شَأْنِها أنْ تُحْزِنَ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - وتُؤْسِفُهُ، فَمِن ذَلِكَ:
▪︎ كُفْرُهم كَما قالَ تَعالى ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذا الحَدِيثِ أسَفًا﴾ [الكهف: ٦]،
▪︎ ومِنهُ حُلُولُ العَذابِ بِهِمْ مِثْلُ ما حَلَّ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَإنَّهم سادَةُ أهْلِ مَكَّةَ، فَلَعَلَّ الرَّسُولَ ﷺ أنْ يَتَحَسَّرَ عَلى إصْرارِهِمْ حَتّى حَلَّ بِهِمْ ما حَلَّ مِنَ العَذابِ.
فَفي هَذا النَّهْيِ كِنايَةٌ عَنْ قِلَّةِ الِاكْتِراثِ بِهِمْ، وعَنْ تَوَعُّدِهِمْ بِأنْ سَيَحِلُّ بِهِمْ ما يُثِيرُ الحُزْنَ لَهم" (التحرير والتنوير)
📗"الصَّحِيحُ في مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: أنَّ اللَّهَ نَهى نَبِيَّهُ ﷺ عَنِ الحُزْنِ عَلى الكُفّارِ إذا امْتَنَعُوا مِن قَبُولِ الإسْلامِ. ويَدُلُّ لِذَلِكَ كَثْرَةُ وُرُودِ هَذا المَعْنى في القُرْآنِ العَظِيمِ.
• كَقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تَكُ في ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]،
• وقَوْلِهِ: ﴿فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ﴾ [فاطر: ٨]،
• وقَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ألّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾،
• وقَوْلِهِ: ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذا الحَدِيثِ أسَفًا﴾ [الكهف: ٦]،
• وقَوْلِهِ: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنهم ما أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيانًا وكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلى القَوْمِ الكافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٨]،
إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.
والمَعْنى: قَدْ بَلَّغْتَ ولَسْتَ مَسْئُولًا عَنْ شَقاوَتِهِمْ إذا امْتَنَعُوا مِنَ الإيمانِ، فَإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ وعَلَيْنا الحِسابُ، فَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إذا كانُوا أشْقِياءَ." (الشنقيطي)
2️⃣اليقين
في قَوْلُهُ تعالى:
﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾
📔"قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سَالِمٌ: (الْمَوْت)
وَسَالِمٌ هَذَا هُوَ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَغَيْرُهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾
[الْمُدَّثِّرِ: ٤٣-٤٧]
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْيَقِينَ الْمَوْتُ حَدِيثُ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ.
وفيه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ -وَقَدْ مَاتَ -قُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله أكرمه؟ " فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ؟ فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ"
(البخاري)
وَيُسْتَدَلُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ -عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب".
اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ
أعمال القلوب
وَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُمْ. وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ وَجَهْلٌ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَانُوا هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِحُقُوقِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَكْثَرَ النَّاسِ عِبَادَةً وَمُوَاظَبَةً عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ إِلَى حِينِ الْوَفَاةِ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هَاهُنَا الْمَوْتُ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْهِدَايَةِ، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أَنْ يَتَوَفَّانَا عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَأَحْسَنِهَا فَإِنَّهُ جواد كريم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل".
(ابن كثير)
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ يَقِينًا أَشْبَهَ بِالشَّكِّ مِنْ يَقِينِ النَّاسِ بِالْمَوْتِ ثُمَّ لَا يَسْتَعِدُّونَ لَهُ، يَعْنِي كَأَنَّهُمْ فِيهِ شَاكُّونَ.
📕﴿حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾؛
" بِما يَشْرَحُ صَدْرَكَ مِنَ المَوْتِ؛ أوْ ما يُوعَدُونَ بِهِ؛ مِنَ السّاعَةِ؛ أوْ غَيْرِها مِمّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَهُ لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ." (البقاعي)
📚 "وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ شَرَفَ العَبْدِ في العُبُودِيَّةِ؛ وأنَّ العِبادَةَ لا تَسْقُطُ عَنِ العَبْدِ بِحالٍ؛ ما دامَ حَيًّا". (الرازي)
"وهَذا مَعْنى ما في سُورَةِ ”مَرْيَمَ“ - عَلَيْها السَّلامُ - ﴿وأوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣١] (البغوي)
📗"اعْلَمْ أنَّ ما يُفَسِّرُ بِهِ هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ بَعْضُ الزَّنادِقَةِ الكَفَرَةِ المُدَّعِينَ لِلتَّصَوُّفِ، مِن أنَّ مَعْنى اليَقِينِ المَعْرِفَةَ بِاللَّهِ - جَلَّ وعَلا -، وأنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ العَبْدَ إذا وصَلَ مِنَ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ إلى تِلْكَ الدَّرَجَةِ المُعَبَّرَ عَنْها بِاليَقِينِ، أنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ العِباداتُ والتَّكالِيفُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ اليَقِينَ هو غايَةُ الأمْرِ بِالعِبادَةِ.
إنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ بِهَذا كُفْرٌ بِاللَّهِ وزَنْدَقَةٌ، وخُرُوجٌ عَنْ مِلَّةِ الإسْلامِ بِإجْماعِ المُسْلِمِينَ. وهَذا النَّوْعُ لا يُسَمّى في الِاصْطِلاحِ تَأْوِيلًا، بَلْ يُسَمّى لَعِبًا كَما قَدَّمْنا في ”آلِ عِمْرانَ“ . ومَعْلُومٌ أنَّ الأنْبِياءَ - صَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ هم وأصْحابُهُ - هم أعْلَمُ النّاسِ بِاللَّهِ، وأعْرُفُهم بِحُقُوقِهِ وصِفاتِهِ وما يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وكانُوا مَعَ ذَلِكَ أكْثَرَ النّاسِ عِبادَةً لِلَّهِ - جَلَّ وعَلا -، وأشَدَّهم خَوْفًا مِنهُ وطَمَعًا في رَحْمَتِهِ. وقَدْ قالَ - جَلَّ وعَلا -: ﴿إنَّما يَخْشى اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ﴾ [فاطر: ٢٨] . والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى" (الشنقيطي)
📓وَقالَ صاحِبُ الدُّرِّ المَنثُورِ: أخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ في التّارِيخِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، والدَّيْلَمِيُّ، عَنْ أبِي مُسْلِمٍ الخَوْلانِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«" ما أُوحِيَ إلَيَّ أنْ أجْمَعَ المالَ وأكُونَ مِنَ التّاجِرِينَ، ولَكِنْ أُوحِيَ إلَيَّ أنْ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ واعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾» [الحجر: ٩٨ - ٩٩] .
وَأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ والدَّيْلَمِيُّ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«" ما أُوحِيَ إلَيَّ أنْ أكُونَ تاجِرًا ولا أجْمَعُ المالَ مُتَكاثِرًا، ولَكِنْ أُوحِيَ إلَيَّ أنْ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ واعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾» .
وحسبنا الله ونعم الوكيل".
(ابن كثير)
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ يَقِينًا أَشْبَهَ بِالشَّكِّ مِنْ يَقِينِ النَّاسِ بِالْمَوْتِ ثُمَّ لَا يَسْتَعِدُّونَ لَهُ، يَعْنِي كَأَنَّهُمْ فِيهِ شَاكُّونَ.
📕﴿حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾؛
" بِما يَشْرَحُ صَدْرَكَ مِنَ المَوْتِ؛ أوْ ما يُوعَدُونَ بِهِ؛ مِنَ السّاعَةِ؛ أوْ غَيْرِها مِمّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَهُ لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ." (البقاعي)
📚 "وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ شَرَفَ العَبْدِ في العُبُودِيَّةِ؛ وأنَّ العِبادَةَ لا تَسْقُطُ عَنِ العَبْدِ بِحالٍ؛ ما دامَ حَيًّا". (الرازي)
"وهَذا مَعْنى ما في سُورَةِ ”مَرْيَمَ“ - عَلَيْها السَّلامُ - ﴿وأوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣١] (البغوي)
📗"اعْلَمْ أنَّ ما يُفَسِّرُ بِهِ هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ بَعْضُ الزَّنادِقَةِ الكَفَرَةِ المُدَّعِينَ لِلتَّصَوُّفِ، مِن أنَّ مَعْنى اليَقِينِ المَعْرِفَةَ بِاللَّهِ - جَلَّ وعَلا -، وأنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلى أنَّ العَبْدَ إذا وصَلَ مِنَ المَعْرِفَةِ بِاللَّهِ إلى تِلْكَ الدَّرَجَةِ المُعَبَّرَ عَنْها بِاليَقِينِ، أنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ العِباداتُ والتَّكالِيفُ؛ لِأنَّ ذَلِكَ اليَقِينَ هو غايَةُ الأمْرِ بِالعِبادَةِ.
إنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ بِهَذا كُفْرٌ بِاللَّهِ وزَنْدَقَةٌ، وخُرُوجٌ عَنْ مِلَّةِ الإسْلامِ بِإجْماعِ المُسْلِمِينَ. وهَذا النَّوْعُ لا يُسَمّى في الِاصْطِلاحِ تَأْوِيلًا، بَلْ يُسَمّى لَعِبًا كَما قَدَّمْنا في ”آلِ عِمْرانَ“ . ومَعْلُومٌ أنَّ الأنْبِياءَ - صَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ هم وأصْحابُهُ - هم أعْلَمُ النّاسِ بِاللَّهِ، وأعْرُفُهم بِحُقُوقِهِ وصِفاتِهِ وما يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وكانُوا مَعَ ذَلِكَ أكْثَرَ النّاسِ عِبادَةً لِلَّهِ - جَلَّ وعَلا -، وأشَدَّهم خَوْفًا مِنهُ وطَمَعًا في رَحْمَتِهِ. وقَدْ قالَ - جَلَّ وعَلا -: ﴿إنَّما يَخْشى اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ﴾ [فاطر: ٢٨] . والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى" (الشنقيطي)
📓وَقالَ صاحِبُ الدُّرِّ المَنثُورِ: أخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ في التّارِيخِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، والدَّيْلَمِيُّ، عَنْ أبِي مُسْلِمٍ الخَوْلانِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«" ما أُوحِيَ إلَيَّ أنْ أجْمَعَ المالَ وأكُونَ مِنَ التّاجِرِينَ، ولَكِنْ أُوحِيَ إلَيَّ أنْ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ واعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾» [الحجر: ٩٨ - ٩٩] .
وَأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ والدَّيْلَمِيُّ، عَنْ أبِي الدَّرْداءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«" ما أُوحِيَ إلَيَّ أنْ أكُونَ تاجِرًا ولا أجْمَعُ المالَ مُتَكاثِرًا، ولَكِنْ أُوحِيَ إلَيَّ أنْ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ واعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾» .
اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ
الخشوع في الصلاة
#الصلاة ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله:
"ههنا أمرٌ عجيبٌ، يحصل لمن تفقَّه قلبه في معاني الأسماء والصِّفات، وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكُلِّ اسمٍ وصفةٍ موضعًا من صلاته، ومحلًّا منها.
💜القيام للصلاة:
فإنَّه إذا انتصب قائمًا بين يَدَي الرَّب تعالى شاهد بقلبه قيُّومِيَّته.
🩷تكبيرة الإحرام:
وإذا قال: «الله أكبر» شاهد كبرياءه.
❤️دعاء الاستفتاح:
فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك»
شاهد بقلبه ربًّا منزَّهًا عن كُلِّ عيبٍ، سالمًا من كُلِّ نقصٍ، محمودًا بكُلِّ حمدٍ.
فحَمْدُه يتضمَّنُ وصْفه بكُلِّ كمالٍ، وذلك يستلزم براءَتَه من كُلِّ نقصٍ، تبارك اسمه.
فلا يُذْكَر على قليلٍ إلَّا كثَّره، ولا على خيرٍ إلَّا أنْمَاه وبارك فيه، ولا على آفةٍ إلَّا أذهبها، ولا على شيطانٍ إلَّا ردَّه خاسئًا داحِرًا.
وكمال الاسم من كمال مسمَّاه، فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا
يضرُّ معه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماء، فشأن المسمَّى أعْلى وأجلُّ.
و «تعالى جَدُّه»
أي: ارتفعت عظمتُه، وجلَّت فوق كُلِّ عظمةٍ، وعلا شأنُه على كُلِّ شأنٍ، وقَهَر سلطانُه على كُلِّ سلطانٍ.
فتعالى جَدُّه أن يكون معه شريكٌ في ملكه وربوبيته، أو في إلهيَّته، أو في أفعاله، أو في صفاته، كما قال مؤمنو الجنِّ: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن/٣].
🩵الاستعاذة:
فإذا قال: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه الشَّديد، واعتصم بحولِه وقوَّتِه من عدوِّه، الذي يريد أنْ يقطعه عن ربِّه، ويباعده عن قُرْبِه، ليكون أسوأ حالًا.
💚الفاتحة
●فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
وقف هنيةً يسيرةً، ينتظر جواب ربِّه له، بقوله: «حمدني عبدي».
فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
انتظر الجواب بقوله: «أثْنى علَيَّ عبدي».
فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾
انتظر جوابه: «يمجِّدُني عبدي».
فيا لذَّة قلبه، وقُرَّة عينه، وسرور نفسه بقول ربِّه: «عَبْدِي» ثلاث مرَّاتٍ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشَّهوات، وغيم النُّفُوس لاسْتُطِيرت فرحًا وسرورًا بقول ربِّها وفاطرها ومعبودها: «حمدني عَبْدي»، و «أثنى عليَّ عَبْدي»، و «مجَّدَني عَبْدي».
ثم يكون لقلبه مجالٌ في شهود هذه الأسماء الثَّلاثة، التي هي أصول الأسماء الحُسْنى، وهي: «الله»، و «الرَّب»، و «الرَّحمن».
●فشاهَدَ قلبُه من ذكر اسم «الله» إلهًا معبودًا موحَّدًا مخوفًا، لا يستحقُّ العبادة غيره، ولا تنبغي إلَّا له، قد عَنَت له الوجوه، وخضعت له الموجودات، وخشعت له الأصوات، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء/ ٤٤]،
﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [الروم/٢٦].
وكذلك خَلَق السَّموات والأرض وما بينهما، وخلق الجنَّ والإنس، والطَّير والوحش، والجنَّة والنَّار، وكذلك أرْسَل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشَّرائع، وألزم العباد الأمر والنَّهي.
●وشاهد من ذكر اسمه «ربِّ العالمين» قيُّومًا قام بنفسه، وقام به كل شيءٍ، فهو قائمٌ على كلِّ نفسٍ بخيرها وشرِّها، قد استوى على عرشه، وتفرَّد بتدبير ملكه. فالتَّدبير كلُّه بيَدَيْه، ومصير الأمور كلِّها إليه؛ فمراسيم التَّدبير نازلة من عنده، على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والتَّولية والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرِّين، ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن/٢٩]، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقِّب لحكمه، ولا رادَّ لأمره، ولا مبدِّل لكلماته، تعرج الملائكة والرُّوح إليه، وتُعْرَض الأعمال أول النَّهار وآخره عليه؛ فيقدِّر المقادير، ويوقِّت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها، قائمًا بتدبير ذلك كلِّه وحفظه ومصالحه.
●ثم يشهد عند ذكر اسم «الرَّحمن» ﷻ
ربًّا محسنًا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحبِّبًا إليهم بصُنُوف النِّعم، وسع كلَّ شيءٍ رحمة وعلمًا، وأوسع كلَّ مخلوقٍ نعمةً وفضلًا. فوَسِعَت رحمتُه كلَّ شيءٍ، وسَعَت نعمتُه إلى كلِّ حيٍّ.
فبَلَغَت رحمتُهُ حيث بلغ علمُه؛ فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنَّة برحمته، والنَّار أيضًا برحمته؛ فإنَّها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنَّته، ويطهِّر بها أدران الموحِّدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته.
قال ابن القيم رحمه الله:
"ههنا أمرٌ عجيبٌ، يحصل لمن تفقَّه قلبه في معاني الأسماء والصِّفات، وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكُلِّ اسمٍ وصفةٍ موضعًا من صلاته، ومحلًّا منها.
💜القيام للصلاة:
فإنَّه إذا انتصب قائمًا بين يَدَي الرَّب تعالى شاهد بقلبه قيُّومِيَّته.
🩷تكبيرة الإحرام:
وإذا قال: «الله أكبر» شاهد كبرياءه.
❤️دعاء الاستفتاح:
فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك»
شاهد بقلبه ربًّا منزَّهًا عن كُلِّ عيبٍ، سالمًا من كُلِّ نقصٍ، محمودًا بكُلِّ حمدٍ.
فحَمْدُه يتضمَّنُ وصْفه بكُلِّ كمالٍ، وذلك يستلزم براءَتَه من كُلِّ نقصٍ، تبارك اسمه.
فلا يُذْكَر على قليلٍ إلَّا كثَّره، ولا على خيرٍ إلَّا أنْمَاه وبارك فيه، ولا على آفةٍ إلَّا أذهبها، ولا على شيطانٍ إلَّا ردَّه خاسئًا داحِرًا.
وكمال الاسم من كمال مسمَّاه، فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا
يضرُّ معه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماء، فشأن المسمَّى أعْلى وأجلُّ.
و «تعالى جَدُّه»
أي: ارتفعت عظمتُه، وجلَّت فوق كُلِّ عظمةٍ، وعلا شأنُه على كُلِّ شأنٍ، وقَهَر سلطانُه على كُلِّ سلطانٍ.
فتعالى جَدُّه أن يكون معه شريكٌ في ملكه وربوبيته، أو في إلهيَّته، أو في أفعاله، أو في صفاته، كما قال مؤمنو الجنِّ: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن/٣].
🩵الاستعاذة:
فإذا قال: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه الشَّديد، واعتصم بحولِه وقوَّتِه من عدوِّه، الذي يريد أنْ يقطعه عن ربِّه، ويباعده عن قُرْبِه، ليكون أسوأ حالًا.
💚الفاتحة
●فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
وقف هنيةً يسيرةً، ينتظر جواب ربِّه له، بقوله: «حمدني عبدي».
فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
انتظر الجواب بقوله: «أثْنى علَيَّ عبدي».
فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾
انتظر جوابه: «يمجِّدُني عبدي».
فيا لذَّة قلبه، وقُرَّة عينه، وسرور نفسه بقول ربِّه: «عَبْدِي» ثلاث مرَّاتٍ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشَّهوات، وغيم النُّفُوس لاسْتُطِيرت فرحًا وسرورًا بقول ربِّها وفاطرها ومعبودها: «حمدني عَبْدي»، و «أثنى عليَّ عَبْدي»، و «مجَّدَني عَبْدي».
ثم يكون لقلبه مجالٌ في شهود هذه الأسماء الثَّلاثة، التي هي أصول الأسماء الحُسْنى، وهي: «الله»، و «الرَّب»، و «الرَّحمن».
●فشاهَدَ قلبُه من ذكر اسم «الله» إلهًا معبودًا موحَّدًا مخوفًا، لا يستحقُّ العبادة غيره، ولا تنبغي إلَّا له، قد عَنَت له الوجوه، وخضعت له الموجودات، وخشعت له الأصوات، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء/ ٤٤]،
﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [الروم/٢٦].
وكذلك خَلَق السَّموات والأرض وما بينهما، وخلق الجنَّ والإنس، والطَّير والوحش، والجنَّة والنَّار، وكذلك أرْسَل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشَّرائع، وألزم العباد الأمر والنَّهي.
●وشاهد من ذكر اسمه «ربِّ العالمين» قيُّومًا قام بنفسه، وقام به كل شيءٍ، فهو قائمٌ على كلِّ نفسٍ بخيرها وشرِّها، قد استوى على عرشه، وتفرَّد بتدبير ملكه. فالتَّدبير كلُّه بيَدَيْه، ومصير الأمور كلِّها إليه؛ فمراسيم التَّدبير نازلة من عنده، على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والتَّولية والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرِّين، ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن/٢٩]، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقِّب لحكمه، ولا رادَّ لأمره، ولا مبدِّل لكلماته، تعرج الملائكة والرُّوح إليه، وتُعْرَض الأعمال أول النَّهار وآخره عليه؛ فيقدِّر المقادير، ويوقِّت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها، قائمًا بتدبير ذلك كلِّه وحفظه ومصالحه.
●ثم يشهد عند ذكر اسم «الرَّحمن» ﷻ
ربًّا محسنًا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحبِّبًا إليهم بصُنُوف النِّعم، وسع كلَّ شيءٍ رحمة وعلمًا، وأوسع كلَّ مخلوقٍ نعمةً وفضلًا. فوَسِعَت رحمتُه كلَّ شيءٍ، وسَعَت نعمتُه إلى كلِّ حيٍّ.
فبَلَغَت رحمتُهُ حيث بلغ علمُه؛ فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنَّة برحمته، والنَّار أيضًا برحمته؛ فإنَّها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنَّته، ويطهِّر بها أدران الموحِّدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته.
اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ
الخشوع في الصلاة
فتأمَّل ما في أمره ونهيه، ووصاياه ومواعظه؛ من الرَّحمة البالغة، والنِّعمة السَّابغة، وما في حشو مخلوقاته من الرَّحمة والنِّعمة.
فالرحمة هي السَّبب المتَّصل منه بعباده، كما أنَّ العبودية هي السَّبب المتَّصل به منهم، فمِنهم إليه العبوديَّة، ومنه إليهم الرَّحمة.
ومن أخصِّ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلِّي نصيبه من الرَّحمة، الذي أقامه بين يَدَي ربِّه، وأهَّلَه لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به.
●فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحقِّ المبين؛ فيشهد ملكًا قاهرًا، قد دانت له الخليقة، وعَنَت له الوجوه، وذلَّت لعظمته الجبابرة، وخضع لعِزَّته كلُّ عزيزٍ، فيشهد بقلبه:
مَلِيكًا على عَرشِ السَّماء مُهَيْمِنًا … لِعِزَّتِه تَعْنُو الوُجُوهُ وتسْجُدُ
وإذا لم يُعَطِّل حقيقة صفة المُلْكِ أطْلَعَتْهُ على شهود حقائق الأسماء والصِّفات، التي تعطيلها تعطيلٌ لمُلْكِه وجحدٌ له؛ فإنَّ الملِكَ الحقَّ، التَّامَّ المُلْكِ لا يكون إلَّا حيًّا، قيُّومًا، سميعًا، بصيرًا، مُريدًا، قادِرًا، متكلِّمًا، آمِرًا، ناهيًا، مستويًا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحقُّ الرِّضا، ويثيبُه ويكْرِمُه ويُدْنِيه، ويغضب على من يستحقُّ الغضب، ويعاقبه ويهينُه ويقْصِيه؛ فيعذِّب من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء ، ويقرِّب من يشاء، ويُقْصِي من يشاء، له دار عذابٍ وهي
النَّار، وله دار سعادة وهي الجنَّة.
فمَنْ أبطل شيئًا من ذلك، أوجحده، أو أنكر حقيقته= فقد قدح في ملكه، ونفى عنه كماله وتمامه.
وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره، فقد أنكر عموم ملكه وكماله، فيشهد المصلِّي مجد الرَّبِّ تعالى في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾."
يتبع إن شاء الله
#اقرأ وارتق ورتل
فالرحمة هي السَّبب المتَّصل منه بعباده، كما أنَّ العبودية هي السَّبب المتَّصل به منهم، فمِنهم إليه العبوديَّة، ومنه إليهم الرَّحمة.
ومن أخصِّ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلِّي نصيبه من الرَّحمة، الذي أقامه بين يَدَي ربِّه، وأهَّلَه لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به.
●فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحقِّ المبين؛ فيشهد ملكًا قاهرًا، قد دانت له الخليقة، وعَنَت له الوجوه، وذلَّت لعظمته الجبابرة، وخضع لعِزَّته كلُّ عزيزٍ، فيشهد بقلبه:
مَلِيكًا على عَرشِ السَّماء مُهَيْمِنًا … لِعِزَّتِه تَعْنُو الوُجُوهُ وتسْجُدُ
وإذا لم يُعَطِّل حقيقة صفة المُلْكِ أطْلَعَتْهُ على شهود حقائق الأسماء والصِّفات، التي تعطيلها تعطيلٌ لمُلْكِه وجحدٌ له؛ فإنَّ الملِكَ الحقَّ، التَّامَّ المُلْكِ لا يكون إلَّا حيًّا، قيُّومًا، سميعًا، بصيرًا، مُريدًا، قادِرًا، متكلِّمًا، آمِرًا، ناهيًا، مستويًا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحقُّ الرِّضا، ويثيبُه ويكْرِمُه ويُدْنِيه، ويغضب على من يستحقُّ الغضب، ويعاقبه ويهينُه ويقْصِيه؛ فيعذِّب من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء ، ويقرِّب من يشاء، ويُقْصِي من يشاء، له دار عذابٍ وهي
النَّار، وله دار سعادة وهي الجنَّة.
فمَنْ أبطل شيئًا من ذلك، أوجحده، أو أنكر حقيقته= فقد قدح في ملكه، ونفى عنه كماله وتمامه.
وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره، فقد أنكر عموم ملكه وكماله، فيشهد المصلِّي مجد الرَّبِّ تعالى في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾."
يتبع إن شاء الله
#اقرأ وارتق ورتل
قال ابن القيم رحمه الله:
❤️{ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* }
"فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة /٤] ففيهما سِرُّ الخلق والأمر، والدُّنيا والآخرة، وهي متضمِّنة لأَجَلِّ الغايات، وأفضل الوسائل:
- فأجلُّ الغايات: عبوديَّتُه.
-وأفضل الوسائل: إعانته.
فلا معبود يستحقُّ العبادة إلَّا هو، ولا معين على عبادته غيره..
فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجلُّ الوسائل.
وقد أنزل الله مائة كتابٍ وأربعة كتبٍ، جمع معانيها في أربعة كتبٍ، وهي التَّوراة والإنجيل والقرآن والزَّبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيه في المفصَّل، وجمع معانيه في الفاتحة، وجمع معانيها في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
وقد اشتملت هذه الكلمة على نَوْعَي التَّوحيد، وهما توحيد الرُّبُوبية، وتوحيد الإلهية، وتضمَّنَت التعبُّد باسم «الرَّبِّ» واسم «الله»، فهو يُعْبَد بألوهيَّته، ويُستَعان بربوبيَّته، ويهدي إلى الصِّراط المستقيم برحمته.
فكان أول السُّورة ذكر اسمه «الله» و «الرَّبِّ» و«الرَّحمن» مطابقًا لأَجَلِّ المطالبِ؛ من عبادته وإعانته وهدايته.
وهو المتفرِّد بإعطاء ذلك كلِّه، لا يعين على عبادته سواه، ولا يهدي سواه.
💛{ *اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}*
ثم يشهد الدَّاعي بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ شدَّة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة، التي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقةً وحاجةً منه إليها ألبتَّة؛ فإنَّه محتاجٌ إليه في كُلِّ نَفَسٍ وطرفة عينٍ.
وهذا المطلوب من هذا الدُّعاء لا يتمُّ إلَّا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه، وهي:
•• هداية التَّفصيل.
•• وخلق القدرة على الفعل.
•• وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيِّ المحبوب للرَّبِّ.
•• وحفظه عليه من مفسداته حال فعله، وبعد فعله.
ولمَّا كان العبد مفتقرًا في كُلِّ حالٍ إلى هذه الهداية، في جميع ما يأتيه ويذَرُهُ، من:
•• أمورٍ قد أتاها على غير الهداية.
•• فهو يحتاج إلى التَّوبة منها.
•• وأمورٍ هُدِي إلى أصلها دون تفصيلها.
•• أو هُدِي إليها من وجهٍ دون وجهٍ؛ فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها؛ ليزداد هُدًى.
•• وأمورٍ هو يحتاج إلى أن يَحْصُل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي.
•• وأمورٍ هو خالٍ عن اعتقادٍ فيها، فهو يحتاج إلى الهداية فيها.
•• وأمورٍ لم يفعلها، فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية.
•• وأمورٍ قد هُدِي إلى الاعتقاد الحقِّ والعمل الصَّواب فيها، فهو محتاجٌ إلى الثَّبات عليها.
إلى غير ذلك من أنواع الهدايات؛ فَرَضَ الله عز وجل عليه أنْ يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، مرَّاتٍ متعدَّدةً في اليوم واللَّيلة.
🩵{ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ* }
ثم بيَّن أنَّ أهل هذه الهداية هم المختصُّون بنعمته، دون ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتَّبعُوه، ودون ﴿الضَّالِّينَ﴾، وهم الذين عبدوا الله بغير علمٍ.
فالطَّائفتان اشتركتا في القول على الله في: خلقه، وأمره، وأسمائه وصفاته بغير علمٍ.
فسبيل المُنْعَمِ عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل كُلِّها علمًا وعملًا.
💚( *آمين* )
فلمَّا فرغ من هذا الثَّناء والدُّعاء والتَّوحيد شرع له أنْ يطبع على ذلك بطابعٍ من التَّأمين، يكون كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السَّماء.
وهذا التَّأمين من زِينة الصَّلاة، كرفع اليَدَيْن الذي هو زِينة الصَّلاة، واتباع للسُّنَّة، وتعظيم أمر الله، وعبوديَّة لليَدَيْن، وشعار الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ."
❤️{ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* }
"فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة /٤] ففيهما سِرُّ الخلق والأمر، والدُّنيا والآخرة، وهي متضمِّنة لأَجَلِّ الغايات، وأفضل الوسائل:
- فأجلُّ الغايات: عبوديَّتُه.
-وأفضل الوسائل: إعانته.
فلا معبود يستحقُّ العبادة إلَّا هو، ولا معين على عبادته غيره..
فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجلُّ الوسائل.
وقد أنزل الله مائة كتابٍ وأربعة كتبٍ، جمع معانيها في أربعة كتبٍ، وهي التَّوراة والإنجيل والقرآن والزَّبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيه في المفصَّل، وجمع معانيه في الفاتحة، وجمع معانيها في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
وقد اشتملت هذه الكلمة على نَوْعَي التَّوحيد، وهما توحيد الرُّبُوبية، وتوحيد الإلهية، وتضمَّنَت التعبُّد باسم «الرَّبِّ» واسم «الله»، فهو يُعْبَد بألوهيَّته، ويُستَعان بربوبيَّته، ويهدي إلى الصِّراط المستقيم برحمته.
فكان أول السُّورة ذكر اسمه «الله» و «الرَّبِّ» و«الرَّحمن» مطابقًا لأَجَلِّ المطالبِ؛ من عبادته وإعانته وهدايته.
وهو المتفرِّد بإعطاء ذلك كلِّه، لا يعين على عبادته سواه، ولا يهدي سواه.
💛{ *اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}*
ثم يشهد الدَّاعي بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ شدَّة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة، التي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقةً وحاجةً منه إليها ألبتَّة؛ فإنَّه محتاجٌ إليه في كُلِّ نَفَسٍ وطرفة عينٍ.
وهذا المطلوب من هذا الدُّعاء لا يتمُّ إلَّا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه، وهي:
•• هداية التَّفصيل.
•• وخلق القدرة على الفعل.
•• وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيِّ المحبوب للرَّبِّ.
•• وحفظه عليه من مفسداته حال فعله، وبعد فعله.
ولمَّا كان العبد مفتقرًا في كُلِّ حالٍ إلى هذه الهداية، في جميع ما يأتيه ويذَرُهُ، من:
•• أمورٍ قد أتاها على غير الهداية.
•• فهو يحتاج إلى التَّوبة منها.
•• وأمورٍ هُدِي إلى أصلها دون تفصيلها.
•• أو هُدِي إليها من وجهٍ دون وجهٍ؛ فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها؛ ليزداد هُدًى.
•• وأمورٍ هو يحتاج إلى أن يَحْصُل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي.
•• وأمورٍ هو خالٍ عن اعتقادٍ فيها، فهو يحتاج إلى الهداية فيها.
•• وأمورٍ لم يفعلها، فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية.
•• وأمورٍ قد هُدِي إلى الاعتقاد الحقِّ والعمل الصَّواب فيها، فهو محتاجٌ إلى الثَّبات عليها.
إلى غير ذلك من أنواع الهدايات؛ فَرَضَ الله عز وجل عليه أنْ يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، مرَّاتٍ متعدَّدةً في اليوم واللَّيلة.
🩵{ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ* }
ثم بيَّن أنَّ أهل هذه الهداية هم المختصُّون بنعمته، دون ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتَّبعُوه، ودون ﴿الضَّالِّينَ﴾، وهم الذين عبدوا الله بغير علمٍ.
فالطَّائفتان اشتركتا في القول على الله في: خلقه، وأمره، وأسمائه وصفاته بغير علمٍ.
فسبيل المُنْعَمِ عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل كُلِّها علمًا وعملًا.
💚( *آمين* )
فلمَّا فرغ من هذا الثَّناء والدُّعاء والتَّوحيد شرع له أنْ يطبع على ذلك بطابعٍ من التَّأمين، يكون كالخاتم له، وافق فيه ملائكة السَّماء.
وهذا التَّأمين من زِينة الصَّلاة، كرفع اليَدَيْن الذي هو زِينة الصَّلاة، واتباع للسُّنَّة، وتعظيم أمر الله، وعبوديَّة لليَدَيْن، وشعار الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ."
#متشابهات الأنعام
📖 قال تعالى:
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنعام : 100]
⏪ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنبياء: 22]
⏪ {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[المؤمنون: 91]
⏪ {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 159]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 180]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الزخرف: 82]
📖 قال تعالى:
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنعام : 100]
⏪ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنبياء: 22]
⏪ {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[المؤمنون: 91]
⏪ {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 159]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 180]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الزخرف: 82]
#متشابهات الأنعام
📖 قال تعالى:
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنعام : 100]
⏪ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنبياء: 22]
⏪ {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[المؤمنون: 91]
⏪ {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 159]
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 180]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الزخرف: 82]
📝📝📝
في المؤمنون والصافات.
في سياق نفي الولد عن الله تعالى في كلا الموضعين.
في الأنعام:
{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
وردت كذلك في سياق نفي الولد من الجن، والبنات من الملائكة.
١- في (الأنبياء) مقترنا بذكر الألوهية:
{فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
٢- في (الزخرف) مقترنا بذكر الربوبية:
{سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
في (الصافات):
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
📝📝📝
📝 ينبه تعالى في هذه الآيات الكريمة على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله!
ولهذا قال تعالى :
{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد، والنظراء والشركاء؛ فإنه فرد أحد صمد، لا نظير له ولا كفء له.
له القوة جميعا، وله العزة جميعا، وليس له ولي من الذل، وله الكبرياء والعظمة جميعا.
👈أنه إذا كان الله تعالى هو رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها، وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى؛ فيتأكد تنزيهه تعالى عن مشاركة المخلوق له في الملك، واتخاذ الولد والصاحبة.
👈وأيضا لأن الشركاء يتنازعون فيما بينهم للوصول إلى العرش؛ كما في قوله تعالى:
{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا.
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء: 42]
أي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى؛ فيكون من علا وقهر هو الرب الإله الواحد القهار، وأما من سواه فهم مربوبون مغلوبون مقهورون متعبدون لله طوعا وكرها.
لما فيه من التهديد؛ إذ هو: الرب الموصوف بالقوة والبطش القادر على الانتقام من هؤلاء المشركين الذين انتقصوا من وحدانية الله تعالى وفرديته وصمديته وقهره وسيادته وهيمنته وجبروته وعلوه وكبريائه؛ بادعاء الولد والشريك له تعالى، تقدس عما يقول الظالمون وعلا علوا كبيرا.
#اقرأ_وارتق_ورتل
📖 قال تعالى:
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنعام : 100]
⏪ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الأنبياء: 22]
⏪ {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[المؤمنون: 91]
⏪ {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 159]
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الصافات: 180]
⏪ {سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
[الزخرف: 82]
📝📝📝
{سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} في موضعين:
في المؤمنون والصافات.
في سياق نفي الولد عن الله تعالى في كلا الموضعين.
وردت بزيادة {وَتَعَالَىٰ} في موضع وحيد
في الأنعام:
{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
وردت كذلك في سياق نفي الولد من الجن، والبنات من الملائكة.
{رَبِّ الْعَرْشِ} في موضعين:
١- في (الأنبياء) مقترنا بذكر الألوهية:
{فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
٢- في (الزخرف) مقترنا بذكر الربوبية:
{سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
{رَبِّ الْعِزَّةِ} في موضع وحيد:
في (الصافات):
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}
📝📝📝
{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
📝 ينبه تعالى في هذه الآيات الكريمة على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله!
ولهذا قال تعالى :
{سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ}
أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد، والنظراء والشركاء؛ فإنه فرد أحد صمد، لا نظير له ولا كفء له.
له القوة جميعا، وله العزة جميعا، وليس له ولي من الذل، وله الكبرياء والعظمة جميعا.
وجه التنزيه بوصف الله تعالى ب(رب العرش) في قوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}
👈أنه إذا كان الله تعالى هو رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها، وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى؛ فيتأكد تنزيهه تعالى عن مشاركة المخلوق له في الملك، واتخاذ الولد والصاحبة.
👈وأيضا لأن الشركاء يتنازعون فيما بينهم للوصول إلى العرش؛ كما في قوله تعالى:
{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا.
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء: 42]
أي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى؛ فيكون من علا وقهر هو الرب الإله الواحد القهار، وأما من سواه فهم مربوبون مغلوبون مقهورون متعبدون لله طوعا وكرها.
وجه التنزيه بوصف الله تعالى بأنه {رَبِّ الْعِزَّةِ}
لما فيه من التهديد؛ إذ هو: الرب الموصوف بالقوة والبطش القادر على الانتقام من هؤلاء المشركين الذين انتقصوا من وحدانية الله تعالى وفرديته وصمديته وقهره وسيادته وهيمنته وجبروته وعلوه وكبريائه؛ بادعاء الولد والشريك له تعالى، تقدس عما يقول الظالمون وعلا علوا كبيرا.
#اقرأ_وارتق_ورتل
اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ
الخشوع في الصلاة دلالات ومعاني الركوع والرفع منه والذكر الوارد فيه
🕌 *أفضل أذكار الصلاة ذكر القيام*
*وأفضل هيئاتها هيئة القيام*
قال ابن القيم رحمه الله:
"وأفضل أذكار الصَّلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلِّي هيئات القيام؛ فخُصَّت بالحمد والثَّناء والمجد، وتلاوة كلام الربِّ ﷻ؛ ولهذا نُهِي عن قراءة القرآن في الركوع والسُّجود؛ لأنَّهما حالتا ذُلٍّ وخضوعٍ وانخفاضٍ؛ ولهذا شُرِع فيهما من الذِّكر ما يناسب هيئتهما، فشُرِع للرَّاكع أنْ يذكر عظمة ربِّه في حال انخفاضه وخضوعه، وأنَّه سبحانه يُوْصَف بوصف عظمته، وتنزيهه عمَّا يضادُّ كبرياءه وجلاله وعظمته.
فأفضل ما يقول الرَّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم»؛ فإنَّ الله سبحانه أمر العِبَاد بذلك، وعيَّن المبلِّغَ عنه، السَّفِير بينه وبين عباده هذا المحلَّ لهذا الذِّكر، لمَّا نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة/٧٤]، قال: «اجعلوها في ركوعكم».
وأبطل كثيرٌ من أهل العِلْم صلاة من تركها -أي التسبيح- عمدًا، وأوْجَبَ سجود السَّهو على من سَهَا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد، ومن وافقه من أئمَّة الحديث والسُّنة.
وبالجملة: فسِرُّ الرُّكُوع تعظيم الرَّبِّ ﷻ بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: «أمَّا الرُّكوع فعظِّمُوا فيه الرَّب»."
🕌 *أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره*
"ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثَّناء عليه وتمجيده.
فافتتح هذا الشِّعار بقول المصلِّي: «سمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَه»، أي: سَمِعَ سَمْعَ قبولٍ وإجابةٍ.
ثم شفَع بقوله: «ربَّنا ولك الحمد، مِلءَ السَّموات والأرض، ومِلءَما بينهما، ومِلءَ ما شِئتَ من شيءٍ بعد».
ولا يهمل أمر هذه (الواو) في قوله: «ربَّنا ولك الحمد»؛ فإنَّه قد نُدِب الأمر بها في (الصَّحيحَين).
وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما؛ فإنَّ قوله: «ربَّنا» متضمِّنٌ في المعنى: أنت الرَّبُّ والملك القيُّوم، الذي بيديه أَزِمَّة الأمور، وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربَّنا» قولَه: «ولك الحمد»، فتضمَّن ذلك معنى قول الموحِّد: «له الملك وله الحمد».
ثمَّ أخبر عن شأن هذا الحمد، وعظمته قدرًا وصفةً، فقال: «مِلءَ السَّموات ومِلءَ الأرض، ومِلءَ ما بينهما، ومِلءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد». أي: قدر ملءِ العالِم العلوي والسُّفلي، والفضاء الذي بينهما.
فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرَّبُّ بعد ذلك ممَّا يشاؤه، فحمده قد ملأ كلَّ موجودٍ، وملأ ما سيوجد.
وقيل: «ما شئتَ من شيءٍ» وراء العالم؛ فيكون قوله: «بعد» للزَّمان على الأول، وللمكان على الثَّاني.
ثمَّ أتْبَعَ ذلك بقوله: «أهلَ الثَّناء والمجْد»، فعاد الأمر بعد الرَّكعة إلى ما افتتح به الصَّلاة قبل الرَّكعة، من الحمد والثَّناء والمجد.
ثمَّ أتْبَعَ ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريرًا لحمده وتمجيده والثَّناء عليه، وأنَّ ذلك أحق ما نَطَق به العبد، ثمَّ أتْبَع ذلك بالاعتراف بالعبوديَّة، وأنَّ ذلك حُكمٌ عامٌّ لجميع العبيد.
ثمَّ عقَّب ذلك بقوله: «لا مانع لما أعطيت، ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَد».
وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصَّلاة أيضًا. فيقوله في هذين الموضِعَين اعترافًا بتوحيده، وأنَّ النِّعم كلَّها منه. وهذا يتضمَّن أمورًا:
أحدها: أنَّه المتفرِّد بالعطاء والمنع.
الثَّاني: أنَّه إذا أعطى لم يُطِق أحدٌ منع مَنْ أعطاه، وإذا مَنَع لم يُطِق أحدٌ إعطاء من مَنَعَه.
الثَّالث: أنَّه لاينفع عنده، ولا يخلص من عذابه، ولا يُدْني من كرامته جُدُودُ بني آدم وحظوظُهم؛ من المُلْك، والرِّئاسة، والغنى، وطيب العَيش، وغير ذلك؛ إنَّما ينفعهم عنده التَّقرُّب إليه بطاعته، وإيثار مرضاته.
فاشتمل هذا الرَّكن على أفضل الأذكار وأنفع الدُّعاء؛ من حمده، وتمجيده، والثَّناء عليه، والاعتراف له بالعبوديَّة والتَّوحيد، والتنصُّل إليه من الذُّنوب والخطايا. فهو ذِكْرٌ مقصودٌ في ركنٍ مقصودٍ، ليس بدون الركوع والسُّجود."
#اقرأ-وارتق-ورتل
*وأفضل هيئاتها هيئة القيام*
قال ابن القيم رحمه الله:
"وأفضل أذكار الصَّلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلِّي هيئات القيام؛ فخُصَّت بالحمد والثَّناء والمجد، وتلاوة كلام الربِّ ﷻ؛ ولهذا نُهِي عن قراءة القرآن في الركوع والسُّجود؛ لأنَّهما حالتا ذُلٍّ وخضوعٍ وانخفاضٍ؛ ولهذا شُرِع فيهما من الذِّكر ما يناسب هيئتهما، فشُرِع للرَّاكع أنْ يذكر عظمة ربِّه في حال انخفاضه وخضوعه، وأنَّه سبحانه يُوْصَف بوصف عظمته، وتنزيهه عمَّا يضادُّ كبرياءه وجلاله وعظمته.
فأفضل ما يقول الرَّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم»؛ فإنَّ الله سبحانه أمر العِبَاد بذلك، وعيَّن المبلِّغَ عنه، السَّفِير بينه وبين عباده هذا المحلَّ لهذا الذِّكر، لمَّا نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة/٧٤]، قال: «اجعلوها في ركوعكم».
وأبطل كثيرٌ من أهل العِلْم صلاة من تركها -أي التسبيح- عمدًا، وأوْجَبَ سجود السَّهو على من سَهَا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد، ومن وافقه من أئمَّة الحديث والسُّنة.
وبالجملة: فسِرُّ الرُّكُوع تعظيم الرَّبِّ ﷻ بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ: «أمَّا الرُّكوع فعظِّمُوا فيه الرَّب»."
🕌 *أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره*
"ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثَّناء عليه وتمجيده.
فافتتح هذا الشِّعار بقول المصلِّي: «سمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَه»، أي: سَمِعَ سَمْعَ قبولٍ وإجابةٍ.
ثم شفَع بقوله: «ربَّنا ولك الحمد، مِلءَ السَّموات والأرض، ومِلءَما بينهما، ومِلءَ ما شِئتَ من شيءٍ بعد».
ولا يهمل أمر هذه (الواو) في قوله: «ربَّنا ولك الحمد»؛ فإنَّه قد نُدِب الأمر بها في (الصَّحيحَين).
وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما؛ فإنَّ قوله: «ربَّنا» متضمِّنٌ في المعنى: أنت الرَّبُّ والملك القيُّوم، الذي بيديه أَزِمَّة الأمور، وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربَّنا» قولَه: «ولك الحمد»، فتضمَّن ذلك معنى قول الموحِّد: «له الملك وله الحمد».
ثمَّ أخبر عن شأن هذا الحمد، وعظمته قدرًا وصفةً، فقال: «مِلءَ السَّموات ومِلءَ الأرض، ومِلءَ ما بينهما، ومِلءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد». أي: قدر ملءِ العالِم العلوي والسُّفلي، والفضاء الذي بينهما.
فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرَّبُّ بعد ذلك ممَّا يشاؤه، فحمده قد ملأ كلَّ موجودٍ، وملأ ما سيوجد.
وقيل: «ما شئتَ من شيءٍ» وراء العالم؛ فيكون قوله: «بعد» للزَّمان على الأول، وللمكان على الثَّاني.
ثمَّ أتْبَعَ ذلك بقوله: «أهلَ الثَّناء والمجْد»، فعاد الأمر بعد الرَّكعة إلى ما افتتح به الصَّلاة قبل الرَّكعة، من الحمد والثَّناء والمجد.
ثمَّ أتْبَعَ ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريرًا لحمده وتمجيده والثَّناء عليه، وأنَّ ذلك أحق ما نَطَق به العبد، ثمَّ أتْبَع ذلك بالاعتراف بالعبوديَّة، وأنَّ ذلك حُكمٌ عامٌّ لجميع العبيد.
ثمَّ عقَّب ذلك بقوله: «لا مانع لما أعطيت، ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَد».
وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصَّلاة أيضًا. فيقوله في هذين الموضِعَين اعترافًا بتوحيده، وأنَّ النِّعم كلَّها منه. وهذا يتضمَّن أمورًا:
أحدها: أنَّه المتفرِّد بالعطاء والمنع.
الثَّاني: أنَّه إذا أعطى لم يُطِق أحدٌ منع مَنْ أعطاه، وإذا مَنَع لم يُطِق أحدٌ إعطاء من مَنَعَه.
الثَّالث: أنَّه لاينفع عنده، ولا يخلص من عذابه، ولا يُدْني من كرامته جُدُودُ بني آدم وحظوظُهم؛ من المُلْك، والرِّئاسة، والغنى، وطيب العَيش، وغير ذلك؛ إنَّما ينفعهم عنده التَّقرُّب إليه بطاعته، وإيثار مرضاته.
فاشتمل هذا الرَّكن على أفضل الأذكار وأنفع الدُّعاء؛ من حمده، وتمجيده، والثَّناء عليه، والاعتراف له بالعبوديَّة والتَّوحيد، والتنصُّل إليه من الذُّنوب والخطايا. فهو ذِكْرٌ مقصودٌ في ركنٍ مقصودٍ، ليس بدون الركوع والسُّجود."
#اقرأ-وارتق-ورتل
﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِیۤ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلَمۡ یَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ﴾ [الكهف ١]
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال،
وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية،
وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد ﷺ
فحمد نفسه،
وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه،
وهما نفي العوج عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم
فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب،
ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث
وإثبات الاستقامة،
يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات
وهي الأخبار، التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة
وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له.
وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به.
تفسير السعدى
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال،
وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية،
وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد ﷺ
فحمد نفسه،
وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه،
وهما نفي العوج عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم
فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب،
ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث
وإثبات الاستقامة،
يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات
وهي الأخبار، التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة
وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له.
وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به.
تفسير السعدى
❤1